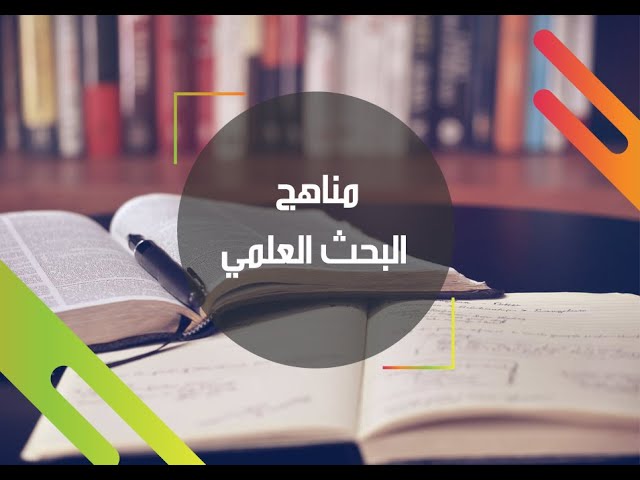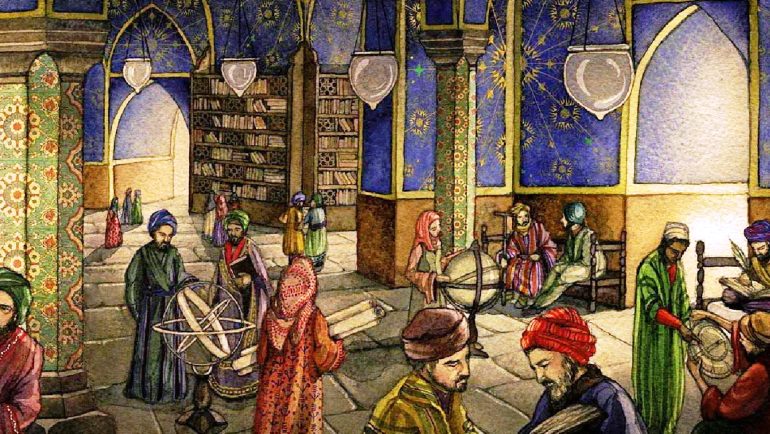حماس أفلاطون في كتابه الجمهورية على أساس الحقيقة القائلة بأنه قد تم حينذاك و للمرة الأولى الاكتشاف الواعي لدلالة و أهمية إحدى الوسائل الكبرى التي تستخدمها كل معرفة علمية و هي المفهوم . و سقراط هو الذي اكتشف المفهوم بما ينطوي عليه من دلالة و مغزى. و على يديه توصل الإغريق لأول مرة إلى هذه الأداة التي في متناول الإنسان بحيث يستطيع بواسطتها أن يحشر غيره بين فكي كماشة منطقية، فلا يفلت من قبضتها إلا عند التسليم بما يلي: إما ان لا يعرف شيئا، أو أن هذا و لا شيئ سواه هو الحقيقة بعينها. و تلك هي التجربة الهائلة التي أشرقت على تلامذة سقراط، فلو تسنى للمرء فقط على المفهوم الصحيح لما هو جميل و خير أو للشجاعة أو للنفس مثلا أو غير ذلك فغنه يتمكن من إدراك وجودها الحقيقي أيضا.
إعلان الجهل: يقول سقراط في الدفاع مثلا لأفلاطون، إنه لا يعرف شيئا، و ليست لديه أية حكمة أو معرفة اللهم إلا حكمة إنسانية ذات طابع سلبي صرف تقول: " أحكم البشر هو من اعترف كسقراط أن حكمته لا تساوي شيئا بالقياس إلى الحقيقة" ( 23أ) . السؤال المطروح هل جهل سقراط حقيقي أم متصنع؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، و لكن المؤكد أنه تعبير عن حالة الشك و عدم الاستقرار الفعلي التي تميزت بها فترة الحرب البيلوبونيزية ، كما أن قول سقراط بالجهل له فوائد أو وظائف منهجية منها: - أنه ييسر البحث المشترك في المسائل المعروضة، و إلا تحول الأمر إلى تلقين و تلق. – يسمح بالنظر في كل الفروض الممكنة، مما يوسع دائرة البحث و يكشف أكثر و أكثر عن معارف الطرف الآخر. – يولد لدى الطرف الآخر وهم أن النتائج التي يصل إليها الطرفان إنما توصل إليها نفسه، و ليس سقراط الذي يكتفي بالسؤال و الاعتراض ثم بالسؤال من جديد.
ب- ، ترجمة عن الكلمة اليونانية eironia
مُبَيَّنَة في الطبيعة البشرية و في القبيلة البشرية نفسها أو الجنس البشري نفسه، فالرأي القائل بأن حواس الإنسان هي مقياس الأشياء إنما هو رأي خاطئ ، فالإدراكات جميعا، الحسية و العقلية هي -على العكس- منسوبة إلى الإنسان و ليس إلى العالَم ، و الذهن البشري أشبه بمرآة غير مستوية تتلقى الأشعة من الأشياء و تمزج طبيعتها الخاصة بطبيعة الأشياء فتشوهها و تفسدها.
فهي الوهام الخاصة بالإنسان الفرد، إن لكل فرد – بالإضافة إلى أخطاء الطبيعة البشرية بعامة- كهفا أو غارا حاصا به يعترض ضياء الطبيعة و يشوهها، قد يحدث هذا بسبب الطبيعة الفريدة و الخاصة لكل إنسان، أو بسبب تربيته و صلاته الخاصة، أو قراءاته و نفوذ أولئك الذين يكن لهم الاحترام و الإعجاب، أو لاختلاف الانطباعات التي تتركها الأشياء في أذهان مختلفة: في ذهن قلق متحير، أو ذهن رصين مطمئن...ألخ. الروح البشرية إذن ( بمختلف ميولها لدى مختلف الأفراد) هي شيئ متغير، و غير مطرد على الإطلاق، و رهن للمصادفة العشواء، و قد صدق هيراقليطس حين قال : عن الناس تلتمس المعرفة في عوالهم الصغرى الخاصة، و ليس في العالم الأكبر أو العام.
، بالنظر إلى ما يجري بين الناس هناك من تبادل و اجتماع، فالناس إنما تتحادث عن طريق القول، و الكلمات يتم اختيارها بما يلائم فهم العامة، و هكذا تنشأ مُدَوَّنَة من الكلمات سيئة بليدة تعيق العقل إعاقة عجيبة، إعاقة لا تجدي فيها التعريفات و الشروح التي دأب المثقفون على التحصن بها أحيانا: فما تزال الألفاظ تَنْتَهِكُ الفهم بشكل واضح، و تُوقِع الخلط في كل شيئ، و تُوقِعُ الناس في مجادلات فارغة و مغالطات لا حصر لها.
، ذلك اني أعتبر أن كل الفلسفات التي تعلمها الناس و ابتكروها حتى الآن هي أشبه بمسرحيات عديدة جدا تُقَّدم و تؤدَّى على المسرح، خالقة عوالم من عندها زائفة وهمية، و لا ينسحب حديثي على الفلسفات و المذاهب الرائجة اليوم فحسب، و لا حتى على المذاهب القديمة فما يزال بالإمكان تأليف الكثير من المسرحيات الأخرى من نفس النمط و تقديمها بنفس الطريقة المصطنعة و إضفاء الاتفاق عليها، ما دامت أسباب أغلاطها الشديدة التعارض هي أسباب مشتركة إلى حد كبير، و لا أنا أقصر حديثي على الفلسفة الكلية، و إنما أشمل أيضا كثيرا من العناصر و المبادئ الخاصة بالعلوم، و التي اكتسبت قوتها الإقناعية من خلال التقليد و التصديق الساذج و القصور الذاتي، غير أننا ينبغي أن نعرض لكل صنف من الأوهام على حدة بتفصيل أكبر، كيما نُحصِّن الفهم البشري ضدها.
) [ هامش : عالم اجتماع و انثربولوجي فرنسي 1908- 2009 يلقب بعميد البنيويين فهو من رواد المذهب البنيوي من أهم مؤلفاته: الأنثربولوجيا البنيوية ، الفكر البري، الأسطورة و المعنى ... ] بخصوص العلوم الإنسانية، أي أنها ليست علوما. منذ قرن من الآن كان التاريخ يحسب نفسه علما، ثم بدأ المؤرخون يعترفون شيئا فشيئا بالوهم، و يعترفون بأنه لا فائدة من قعد أي أمل على تحقيق الموضوعية في التاريخ. إن أخلاق مهنتنا تجبرنا على بذل كل الجهود للتقرب من الواقع، و نحن لا نتحكم إلا في استغلالها بعمق دون استعمالها بشكل سيئ. و لكن يجب ملء الفراغ باستعمال الخيال كما لو أننا نود تركيب لعبة معقدة تتكون من عدة قطع لا نتوفر على معظمها.
ليس الخطاب التاريخي سوى التعبير عن رد فعل شخصي للمؤرخ أما الآثار المتفرقة لانفعاله بل آثار حلمه، لأن عليه أن يحلم بالضرورة، لكن عليه أن يحلو بجدية. و لكن لا يمكن أن نقتسم حلمنا مع قرائنا بتقديم عمليات جرد و إحصاءات و منحنيات ...
المصدر:
محمد الهلالي و حسن بيقي، معايير العلمية، دار توبقال للنشر، ط.1، الدار البيضاء، المغرب، 2015، ص-ص. 34-35
المنهج في الحضارة الغربية
حسن حنفي ( 1935- 2021)
ارتبط المنهج في الغرب بمنطق اليونان بحيث لم يعد هناك فرق بين المنهج و المنطق. المنطق هو منهج الفلسفة لما كانت الفلسفة هي علم البرهان، و لما كان الغالب على منطق اليونان منطق القضايا، الذي قوم في معظمه على الشكل و ليس على المضمون. كان مقياس الحقيقة في اتساق النتائج مع المقدمات، يكون العلم صحيحا ما دامت أشكال الفكر فيه صحيحة. و لقد لخص المسلمون ذلك في قولهم : المنطق إما تصور أو تصديق. و التصور ينال بالحد و التصديق ينال بالبرهان. أما الاستقراء فقد كان هامشيا في المنطق بالرغم من الاتجاه الطبيعي التجريبي عند أرسطو.
و أضاف العصر الوسيط إلى المنهج الاستدلالي القديم منهج التأويل، كما بدأ في نظرية المعاني الأربعة للنص الديني: المعنى الحرفي، المعنى المجازي، و المعنى الأخلاقي، و المعنى الروحي، و أصبح المنهج في مواجهة عقدة في عصر الآباء أو في مواجهة نفسه عند اليونان. و نشأ الصراع بين أنصار المعنى الحرفي من ناحية و أنصار المعاني المجازية و الأخلاقية و الروحية من ناحية أخرى.
و في العصر الحديث بدأ المنهج في التطور بعد القطيعة المعرفية بين الماضي و الحاضر، و رفض المصادر القبلية للمعرفة، الكتاب المقدس، و أقوال الآباء، و أرسطو، و بطليموس... قام المنهج العقلي على نقطة بديهية في الكوجيطو "أنا أفكر أنا موجود" و لكي يكون الفكر صحيحا عليه إتباع قواعد أربع .... و قام المنهج التجريبي على نقطة بديهية أخرى هي أن الحواس مصدر للمعرفة و أن صدق الحكم في مطابقته للواقع من خلال الحواس، و بالتالي تم استبعاد كل ما لا يمكن التحقق من صدقه في الواقع المشاهد و العالم المدرك ... ثم جاءت مرحلة ثانية في الفكر المنهجي ىالغربي عندما تحول العقل إلى جدل و التجربة إلى تحليل. فقد كان العقل في القرن السابع عشر صوريا رياضيا فارغا ثم تحول إلى خطابة و مقال و تنوير الجماهير في القرن الثامن عشر عند فلاسفة التنوير.
المصدر:
حنان قصبي، محمد الهلالي، في المنهج، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، 2015، ص-ص. 16- 17
ميلاد التاريخ الجديد: مدرسة الحوليات ( 1978م)
جاك لوغوف ( 1924- 2014م)
لقد كان لـ التاريخ الجديد تقاليد خاصة به، و هي التقاليد التي أرساها مؤسسو مجلة: حوليات التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي. عندما بعث لوسين فافر و مارك بلوخ مجلة: الحوليات في ستراسبورغ سنة 1929، و هي إحياء مع بعض التعديل لمشروع قديم للوسيان فافر يهدف إلى تأسيس مجلة عالمية للتاريخ الاقتصادي، كانت دوافعهما متعددة.
أولها هو إخراج التاريخ من بؤرة العادات القديمة، و خاصة تحريره من انغلاقه على ذاته، و هو ما عبّر عنه لوسين فافر سنة 1932 بـ " إسقاط الجدران العازلة التي تجاوزها الزمن، و أكداس المسبقات التي تعود إلى عصر بابل من الملل و الأخطاء في التصور و التفهم"
ثانيهما هو الرغبة في التأكيد على اتجاهين مجددبن مضمنين صفتين لعنوان المجلة: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، فبالصفة الأولى "الاقتصادي" كان القصد هو دفع البحث التاريخي في مجال يكاد يكون مغيبا كليا من طرف التاريخ التقليدي، في حين تقدم فيه الإنجليز و الألمان شوطا كبيرا أمام الفرنسيين، و لا غرابة في أن تتزايد أهمية الإنجليز و الألمان في حياة الأمم باطراد. فليس من باب الصدفة أن تنشأ مجلة: الحوليات سنة 1929، و هي سنة اندلاع الأزمة العالمية الكبرى. و كان المؤرخ هنري بيران، الذي كان لا يزال على قيد الحياة آنذاك، مصدر إعجاب لوسين فافر و مارك بلوخ، حتى أن لوسيان فافر كان يعتزم اقتراحه مديرا للمجلة العالمية. و في سنة 1940 أهدى له مارك بلوخ في ذكراه مشروعا بعنوان: " تاريخ المجتمع الفرنسي في سياق الحضارة الأوروبية" لكن سرعان ما وقع التخلي عنه في ما بعد.
المصدر:
جاك لوغوف( تحت إشراف)، التريخ الجديد، ترجمة: محمد الطاهر المنصوري، المنظمة العربية للترجمة، ط.1، بيروت، لبنان، 2007. ص-ص.84- 85
مدرسة الحوليات الحدث و الظرف.( 2022)
أ.د. / طاهر بن علي.
... يؤكد أحد أقطاب مدرسة الحوليات أنه " لا مارك بلوخ، و لا لوسين فيفر، كانت لهما الإرادة أو الوهم في أنهما يؤسسان مدرسة، بصيغها و حلوها. لقد بحثا طوال حياتهما. لقد جمعا بلا نهاية كل الأفكار الجديدة، كلّ المناهج و التقنيات الفعالة، كلّ ما حسحس شيئا فشيئا مهنتنا نحو صيغ تؤول إلى الدقة"
فلم يكن بخلد المؤسسين أنهما يؤسسان لاتجاه جديد، يكون مدرسة قائمة بمناهجها و موضوعاتها و أقطابها، و لكنه كان مسعى نضاليا من أجل التاريخ، من اجل تحرير الكتابة التاريخية من طوق الوثيقة المكتوبة كما أرادتها مدرسة كما أرادتها مدرسة المنهجية، من أجل أن يكون التاريخ رؤى الحاضر لفهم الماضي و تكوين معرفة بالماضي تمتدّ في الحاضر على ضوء فهم يليق بالإنسان الذي هو مجموع الحركات و النشاطات و الفعاليات في الإنسان و محيطياته.
و بهذا السعي تكوّنت الفكرة التأسيسية التي تبلورت بفضل حركية الرواد إلى إنشاء تجمع فكري له خصوياته، و بالأحرى أنشأت تجمعا مماثلا للتجمّع الذي أنشأته مجلة التوليف التاريخي بزعامة هنري بير، يماثله في التفتح على الدراسات الإنسانية و الاجتماعية، و يخالفه في انتقاء المواضيع، و في طرحها، و في قوة لخطاب الذي فرضته ظروف الأزمة المالية سنة 1929، مع النزعة الوطنية التي رانت على الجغرافيا التي اجتمع فيها المؤسسان.
لقد كانت جامعة ستراسبورغ الفضاء و الزمان الذي التقى فيهما طموح بلوخ و لوسين فيفر، إذ جمعهما تعيينهما فيها و كان زمن جامعة ستراسبورغ سنوات الخصوبة بالنسبة لهما. ففي مدينة ستراسبورغ كانت تعقد كل سبت تقريبا اجتماعات منتظمة، سمّيت "اجتماع السبت" يؤمّها جغرافيون، رخون، فلاسفة، علماء اقتصاد، علماء دين و علماء اجتماع، و يعرضون منشورات في ميادينهم، أو ما باشروا بنشره شخصيا.
و قد ساهما بدورهما في جبهة الألزاس المحرّرة، و هي الواجهة الفكرية الفرنسية في مواجهة الجارة ألمانيا. و منها انطلق تجديد التاريخ ليمتد إلى العاصمة ثم إلى باقي فرنسا و أوروبا عموما. و جاء هذا التجديد في بيان مثّلته مجلة حوليات التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي. "... إن البرنامج الفكري الذي حملته المجلّة كان جديدا و متينا. ينتظم حول اقتراح مركزي: من المستعجل إخراج التاريخ من عزلته العلمية، يجب فتحه على الاستفهامات و على مناهج العلوم الاجتماعية الأخرى يجب أن يجاور العلوم في بناء المعارف الإنسانية.
المصدر:
طاهر بن علي، التاريخ في فكر أعلام مدرسة الحوليات، مقاربة معرفية، مجلة روافد للبحوث و الدراسات، مخبر الجنوب الجزائري للبحث في التاريخ و الحضارة الإسلامية، جامعة غرداية، المجلد 7، العدد01، 2022، ص-ص. 6- 8
- Enseignant: brahim tasse
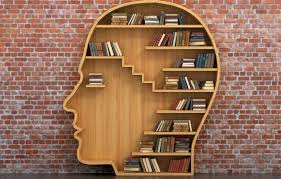
- Enseignant: Aَboubakr Saiti
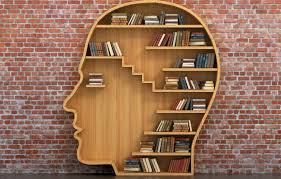
- Enseignant: Aَboubakr Saiti
.
1 / جغرافية القطر الجزائري وطوبونيميتها
/ حضارات الجزائر في ما قبل التاريخ
/ الممالك البربرية
/ العلاقات بين الممالك البربرية والفينيقيين
/ الاحتلال الروماني ومقاومته
/ الوندالي ومقاومته
/ الاحتلال البيزنطي ومقاومته
/ الفتوحات الإسلامية
/ عصر الولاة
/ الدولة الرستمية
/ الدولة الفاطمية
/ الدولة الحمادية
/الدولة المرابطية
/الدولة الموحدية
/ الدولة الزيانية
%-عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام
.. . . .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-. -.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Enseignant: rahima bichi
يتناول مدخل إلى علم الأثار 2 الجانب ميداني للعمل الأثري، والذي يشمل التعريف بالمسح الأثري وكل ما يتعلق به من وسائل وفريق العمل وأنواع المسح الأثري ومراحله، أما المحور الثاني فيتمثل في التعريف التنقيب الأثري من خلال التعرض لتطوره التاريخي، ووسائله وفريق العمل، بالاضافة إلى أهم مراحله ، مع توضيح علاقة كلا العملينين بالتطور الذي يعرفه علم الأثار كعلم حديث قائم بداته.
- Enseignant: yamina bensghir
- Enseignant: abdeldjalil mellakh