- Enseignant: Aicha SIROUKANE
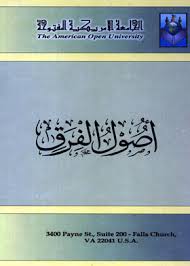
- Enseignant: GHOCHI YAHIA
أضحى الاطلاع على مناهج الحداثيين في قراءة النص القرآني و الحديثي من الأهمية بمكان فيما يتعلق بتكوين طالب العلوم الاسلامية ، لا يمكن للطالب الجامعي اليوم أن يتصدى للتحديات الفكرية التي تهدد الأمن العقدي للأمة إن لم يكن واسع الاطلاع على ما كتبه الحداثيون.
يحتوي المقياس على المواضيع التالية:- التعريف بالحداثة ونشأتها وسماتها في العالم العربي.
- ما بعد الحداثة وسماتها والفرق بينها وبين الحداثة.
- الحداثة العربية وانتقال الحداثة الغربية إلى العالم العربي – بحث إشكالية الهوية في الحداثة العربية-
- مواقف الحداثيين العرب من القرآن وقراءتهم له.
- عينات من المناهج الغربية المعتمدة في قراءة الوحي.
- التاريخية وتطبيقاتها وحاصلها.
- التفكيك أمثلة من تطبيقاته وناتجه.
- عينات من أشهر الحداثيين العرب وطريقة القراءة لديهم: أدونيس ، محمد أركون ، نصر حامد أبو زيد.
- حاصل القراءة الحداثية وأثرها على المعتقد والقيمة والإنسان.
و يجدر بالطالب في الأعمال الموجهة دراسة مؤلفات المفكرين الحداثيين أمثال أركون و الجابري و شحرور.
- تعريف الطالب على الحداثيين الغربية والعربية وعلى مبادئها وعلى مواقفها المختلفة من الدين ومن الموجود وعلى أبعادها ومآلاتها.
2- التعريف بالمناهج الحداثية التي تستهدف الوحي والقيم.
3- تعليم أدوات وآليات القراءة والتحليل والنقد.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
المحاضرة الأولى: ضبط المفاهيم
أولا: مفهوم الحداثة.
- التعريف اللغوي: الحديث نقيض القديم، والحديث: الخبر، والحدوث: كون الشيء بعد أن لم يكن، واستحدثت خبراً: أي وجدت خبرا جديدا.
وفي اللغات الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية) نجد أن كلمة حداثة لفظ أوربي المنشأ، ففي الإنجليزية لفظان Modernism وmodernity ومثلهما في الفرنسية، والترجمة العربية لهذين المصطلحين تختلف من حداثة إلى عصرية إلى معاصرة.
- التعريف الاصطلاحي:
1- عند الغربيين: يجمع الباحثون على أن الحداثة نشأت في فرنسا عام 1830م وأن الحداثي الفرنسي شارل بودلير مؤسسها الأول، ومن هناك انتشرت في الدول الأخرى.
يعرف الفيلسوف الألماني " كانت " الحداثة في سياق إجابته عن سؤال ما الأنوار فيقول: "الأنوار أن يخرج الإنسان من حالة الوصاية التي تتمثل في استخدام فكره دون توجيه من غيره".
ويعرف (رولان بارت) الحداثة بأنها "انفجار معرفي لم يتوصل الإنسان المعاصر إلى السيطرة عليه".
ويصف (جوس أورتيكا كاسيت) الحداثة قائلا: "إن الحداثة هدم تقدمي لكل القيم الإنسانية التي كانت سائدة في الأدب الرومانسي والطبيعي، وأنها لا تعيد صياغة الشكل فقط بل تأخذ الفن إلى ظلمات الفوضى واليأس". والحداثة عند(تورين) باختصار كما يقول في كتابه نقد الحداثة "تستبدل فكرة الله بفكرة العلم، وتقصر الاعتقادات الدينية على الحياة الخاصة بكل فرد".
يقول كالينيو: "إن الحداثة في جوهرها ظاهرة تعكس معارضة جدلية ثلاثية الأبعاد :-معارضة للتراث, ومعارضة للثقافة البرجوازية بمبادئها العقلانية والنفعية، وتصورها لفكرة التقدم، ومعارضة لذاتها كتقليد، أو شكل من أشكال السلطة أو الهيمنة".
من خلال التعريفات نجد:
- الحداثة في الغرب تمثل مذهبا فكريا رافضا للثوابت والمسلّمات القديمة من العقائد والشرائع ذات الطابع الكنسي الشمولي.
- أن الحداثة فكرة لا تقتصر على الجانب الأدبي فقط، إنما هي نظرية وفلسفة تعم وتشمل كافة الجوانب الحياتية اجتماعية كانت أم معرفية أم صناعية أم غيرها، وبالتالي فالحداثيون يقدمون تصورا هداما لحياة الناس يشمل مختلف نواحيها.
- أن الأساس الذي تقوم عليه فكرة الحداثة هو العقل والعقلانية التي تهدر معها كل ما لا يدركه العقل، فالعقل المتحرر من كل سلطان هو معيار أهل الحداثة بل هو السلطان الحاكم على الأشياء.
- الحداثة معاكسة مع الماضي وانقطاع عنه، فهي انفصال للحديث عن القديم، بل هي ثورة على كل قديم مقدس أو غير مقدس.
- إنها الحرية المطلقة التي لا يقف في طريقها ضابط، ولا يحكمها شيء.
- أن الحداثة لا تتحقق إلا بحركة الإنسان حرا طليقا دون وصاية عليه من أي جهة.
- الحداثة فكرة ضد الله والغيب، وفي ذات الوقت لا تتحقق إلا بعزل الدين عن شئون الحياة، وقصره على الشئون الخاصة بكل فرد.
2- تعريف الحداثة عند العرب والمسلمين.
يعرفها أدونيس في كتابه الثابت والتحول بقوله: "هي الصراع بين النظام القائم على السلفية، والرغبة العاملة لتغيير هذا النظام".
ويقول: "لا يمكن أن تنهض الحياة العربية، ويبدع الإنسان العربي إذا لم تنهدم البنية التقليدية السائدة للفكر العربي، ويتخلص من المبنى الديني التقليدي الاتباعي".
ويقسم أدونيس الحداثة إلى أنواع ثلاثة:
الحداثة العلمية: وتعني إعادة النظرة المستمرة في معرفة الطبيعة للسيطرة عليها, وتعميق هذه المعرفة.
الحداثة الثورية: وتعني نشوء حركات ونظريات وأفكار جديدة, ومؤسسات وأنظمة جديدة, تؤدي إلى زوال البنى التقليدية القديمة في المجتمع وقيام بنى جديدة.
الحداثة الفنية: وتعني تساؤلا جذريا يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها, ويفتتح آفاقاً تجريبية جديدة في الممارسة, وابتكار طرق للتعبير تكون في مستوى هذا التساؤل.
ويشترط لكل هذا أن يصدر عن نظرة شخصية فريدة للإنسان والكون.
ويرى جابر عصفور أن الحداثة: "الصياغة المتجددة للمبادئ والأنظمة التي تنتقل بعلاقات المجتمع من مستوى الضرورة إلى الحرية، من الاستغلال إلى العدالة، ومن التبعية إلى الاستقلال ومن الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن سطوة القبيلة أو العائلة أو الطائفة إلى الدولة الحديثة ومن الدولة التسلطية إلى الديمقراطية".
ويقول أيضا: "الحداثة انقطاع معرفي، ذلك أن مصادرها المعرفية لا تكمن في المصادر المعرفية للتراث، في كتب ابن خلدون الأربعة، أو في اللغة المؤسساتية، والفكر الديني، وكون الله مركز الوجود، وكون السلطة السياسية مدار النشاط الفني، وكون الفن محاكاة للعالم الخارجي، الحداثة انقطاع، لأن مصادرها المعرفية هي اللغة البكر، والفكر العلماني، وكون الإنسان مركز الوجود، وكون الشعب الخاضع للسلطة مدار النشاط الفني، وكون الداخل مصدر المعرفة اليقينية- إذا كان ثمة معرفة يقينية، وكون الفن خلقا لواقع جديد".
ثانيا: نشأة الحداثة في العالم العربي:
كان لبعض العوامل التاريخية والسياسية والفكرية أثر في ظهور الحداثة في العالم العربي منها: الحملة الفرنسية على مصر، البعثات الخارجية، الإرساليات التنصيرية، الترجمة، المدرسة المهجرية.
فالتيار الحداثي الإنجليزي استطاع أن يؤثر على الشعر العراقي في الخمسينيات, بينما استطاع التيار الحداثي الفرنسي أن يؤثر على الشعر في لبنان, ومن لبنان انتشرت في سوريا وفلسطين والأردن ومصر.
ومن الرواد الأوائل لهذا التوجه الفكري:
1- جميل صدقي الزهاوي: يعد من أوائل الممهدين للحداثة بثورته في العراق على القيم الاجتماعية والسياسية والأدبية, حيث حارب الحجاب, ودعا إلى تحرير المرأة من الأحكام الشرعية, وطالب بالتبرج والسفور وشجع على نزع الحجاب والاختلاط, كما اعترض على مشروعية تعدد الزوجات, وكرس جهده لمحاربة القواعد الشعرية وإلغاء القوافي.
2- خليل مطران (شاعر القطرين): يكاد يجمع الحداثيون على أن خليل مطران يمثل طليعة الحداثيين, وأستاذ العصرانية, ومن كبار دعاة التحرر من الأساليب القديمة.
3- جبران خليل جبران: والذي يعتبره أدونيس نبيا للحداثة, حيث اعتبر أن له وحيا يكشف له عن الغيب بواسطة الرؤيا الإشراقية التي تتجلى له.
5- معروف الرصافي: وقد اتخذ من مهاجمة العادات والتقاليد الدينية منهجا اجتماعيا, وقد اتخذ من نقده للماضي مدخلا لمهاجمة أحكام الشريعة التي دعا للتخلص منها, كما دعا إلى إنكار الدين والوحي والنبوة والغيبيات, والثواب والعقاب والجنة والنار .
6- يوسف الخال رائد الحداثة الأول في العالم العربي, حيث عمل بعد عودته من دار هجرته في أمريكا إلى بيروت التي سكنها كموطن بديل لبلده سوريا في تنظيم أول تجمع حداثي ضم طائفة من أصحاب التوجهات الماركسية والبعثية والقومية أمثال: أدونيس, وزوجته خالدة سعيد, ونذير العظمة, وأنسي الحاج, وشوقي أبو شقرا, وأسعد رزوق, ومحمد الماغوط.
7- علي أحمد سعيد أسبر, المشهور بأدونيس، شاعر حداثي سوري, نشأ نشأة دينية وتعلم أشعار المتصوفة, يعتبره الحداثيون رائد الحداثة الأول, حيث ظهر ذلك في أطروحته للدكتوراة من الجامعة الأمريكية في بيروت (الثابت والمتحول، بحث في الاتباع والإبداع عند العرب).
وهناك أيضا من المفكرين: محمد أركون الجزائري, محمد عابد الجابري المغربي, صلاح عبد الصبور من رواد الحداثة المصريين, محمود درويش من فلسطين.
رابعا: جذور الحداثة ومصادرها:
(1) الفلسفات اليونانية والرومانية وما انطوت عليه من عقائد وأفكار وثنية، ومذاهب إباحية.
(2) العقيدة اليهودية والنصرانية، إذ أن كثيرا من الحداثيين تأثر بها، واتضح ذلك من أفكارهم وآدابهم وتجارب فلاسفتهم.
(3) الشيوعية المتضمنة للمادية الجدلية، والصراع بين المتناقضات، وكثير من الحداثيين هم من أتباع هيجل وانجلز وماركس وغيرهم.
(4) المذاهب الغربية التي ثارت على الكنيسة، وتمردت على جميع الأديان.
(5) الفلسفة الوجودية، ورائدها جان بول سارتر، حيث سلك سبيله كثير من الحداثيين، الذين دعوا إلى الفرار من الحياة عن طريق الأحلام والخيالات وتقديس وجود الانسان وذاته.
(6) عبادة العقل أو الطبيعة أو التجربة أو الجنس أو الذات ونحو ذلك مما أفرزته الأزمات الفكرية والسياسة والنفسية والاجتماعية التي عاشوها هناك، ثم إن عبادة تلك الأشياء لم تنجح في إسعاد المجتمع الغربي، فتولد من ذلك كله الحداثة الثائرة.
خامسا: أسس الفكر الحداثي:
(1) - حرية التفكير المطلقة في البحث والتعبير:
حيث اتفقوا بأنه لا حداثة بدون حرية, ولتلك الحرية عندهم مفهوم خاص ولها دلالة تخالف مفهوم الحرية التي شرعها الإسلام. يحدد "كانت" طبيعة تلك الحرية التي جعلوها شرطا للتنوير والحداثة بأنها "حرية العقل والتفكير من سلطة المقدس ورجال الكهنوت والكنيسة وأصنام العقل".
ومن هنا أصبحت حريتهم مصدرا للقلق والاضطراب حيث عبثت بالأديان والأخلاق والأعراف السليمة, بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان, وإلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة وإباحة الشذوذ.
(2)- الصراع بين القديم والجديد:
يعمل الحداثيون على تغيير التراث، بمبادئه وعقائده وقيمه، إلى مبادئ وعقائد وقيم حديثة, ويقصدون بالتراث هنا ليس كل ما هو قديم على الإطلاق هكذا ولكن يقصدون به التراث الإسلامي وعلى رأسه القرآن الكريم والسنة المطهرة, كما ينادون بحتمية التحول عن القديم والماضي إلى الحديث والمستقبل عبر طرق شتى، منها ما يسمونه (بتفجير الثورات) وإخضاع ذلك القديم (للعقلانية والديموقراطية)، و(إعادة قراءة) عقائده وقيمه بمنظور حداثي ثوري.
(3) الخروج على التقاليد والتجديد المستمر:
إلى أفكار ومواقف جديدة ، ورؤي حديثة حول الإله والإنسان والكون.
(4) رفض ما هو قديم وثابت:
فهي ترفض القديم والعقائد والشرائع، وما يصدر عنها من قيم وأخلاق وتسعى إلى إنشاء فلسفات جديدة بدلا عنها، وقوانين وضعية، وقيم وتعاليم بشرية، تقوم على أنقاض القديم.
سادسا: مفهوم القراءة الحداثية.
تعني القراءة الحداثية: الأنماط الفكرية التي ظهرت في عالمنا العربي والإسلامي محاوِلةً إيجاد وِئَام بين الثقافة الإسلامية الدينية وبين الطرح الغربي الحديث؛ لتنتج خطابا دينيا متماهيا مع الثقافة الغربية في نظرتها للكون والحياة.
وتقوم هذه القراءة على أساسين:
أ- تبني موقف العلمانية من الدين والأخلاق، فالعلمانية في أسسها الفلسفية تستبعد اعتبار الدين والأخلاق والإيمان محرِّكًا للتاريخ، بل تعتبر التاريخ محكوما بدوافع غريزية محضة ذات بعد سياسي مادي، والخطاب الديني والأخلاقي مجرد غطاء فوقي لإخفاء الدوافع الحقيقية للأحداث، وتركز العلمانية في خطابها على الحاضر واستبعاد الماضي، كما تدعو للتشكيك في الكتب المقدسة وفي كل ما هو ديني.
وقد اصطبغت القراءة الحداثية للنص بأغلب هذه المواصفات مُحَاوِلةً قطع الصلة بالتراث مُغَلِّبَةً للعقل على ما سواه من آليات التعامل مع النصوص، وقد صرح عبد المجيد شرفي أحد رواد المدرسة الحداثية بإخفاق جميع المحاولات التفسيرية للقرآن في إطار القداسة.
كما صرح الجابري بأن العائق الأكبر للعقل العربي أمام النهضة يكمن في السلطات الثلاث:
سلطة النص.
سلطة السلف.
سلطة القياس.
وهذه السلطات الثلاث هي مُحَصِّلةُ النظام المعرفي الذي يُؤَطِّرُ الثقافة الإسلامية، ويحكم انتماءها وطبقا لرؤية الجابري “فإنه لا يمكن تغيير بنية العقل، وتأسيس بنية أخرى إلا بممارسة العقلانية النقدية على التراث الذي يحتفظ بتلك السلطات على شكل بنية عقلية لا شعورية.
فالفكر العربي معيب عند هؤلاء؛ لأنه لا يستطيع ممارسة نشاط فعلي، فهو مقيد بمعطى النص والإجماع والقياس، ومن ثم اتخذ الحداثيون من أَنْسَنَةَ التراث طريقا للإجهاز على الجهاز الدلالي، ومبررا للقراءة المتحللة للنصوص، فمضامين العلمانية ظاهرة في الخطاب الحداثي وفي مبرراته، وإن كان من فرق بين الحداثيين والعلمانيين، فهو في نوعية الهدم التي تُمَارَسُ على النصوص، فالعلماني يهدم الدين من الخارج، والحداثي يحاول هدمه من الداخل.
ب-تطبيق التقنيات المعاصرة على النصوص: فتطبيق آليات فلسفة الحداثة، كالمنهج التفكيكي، وتجاوز الأدوات العلمية التفسيرية هي إحدى الخلفيات الْمُــصَنِّعَةِ للفكرة الحداثية، ولذلك يفسرون جميع المظاهر السياسية والاجتماعية والدينية سلبا أو إيجابا؛ بحسب مسافتها من الحداثة، وأخذها بما تمليه التقنيات المعاصرة.
والمحصلة النهائية للنص كما تبلور في الغرب على يد مدارسه الفكرية تقوم على نزع القداسة عن جميع النصوص دينية كانت أو غير دينية، ثم إعمال التسوية بينها، وإخضاعها لبعض العمليات اللغوية الشكلية الآلية التي تلغي حتى وجود المعنى العلماني في النص، ومن ثم يمكن أن يفسر النص بالشيء ونقيضه، ولا يكون هناك أي تفسير ملزما، باعتبار أن عملية التأويل عملية بشرية يقوم بها القارئ للنص وفق آلياته ومعتقداته، فالنص عند السلفي إطار ومرجع، وعند العلماني غطاء وسند، كما يقرر نصر أبو زيد.
وتظهر سمات التقنيات الحديثة عند الحداثيين في النقاط التالية:
العلمية: ويقصدون بها أن يكون الواقع موضوعا للعلم، والعقل مقياسا للحقيقة.
قانون العلية: ومعناه أن تتم أي عملية معرفية عبر التجربة والمنهج التجريبي، وكل مالم يخضع للتجربة يكون الحديث عنه خرافة، أو أسطورة.
تأسيس المعرفة العقلية على النقد، واستبعاد كل ما هو أسطوري ديني لا يستمد صدقه من الواقع، ويكون الموقف النقدي هو جوهر العقلانية الحديثة.
فلذلك اعتبروا القول بإلهية النصوص يستلزم أن البشر عاجزون بمناهجهم عن فهمها، ويؤكد حسن حنفي على القول ببشرية النصوص فيقول: "وإذا كنا نتبنى القول ببشرية النصوص الدينية، فإن هذا التبني لا يقوم على أساس نفعي إيديولوجي يواجه الفكر الديني السائد والمسيطر، بل يقوم على أساس موضوعي يستند إلى حقائق التاريخ، وإلى حقائق النصوص ذاتها".
ولذا فإنهم يعتبرون القول بالنبوة تجهيل للإنسان وتعبير عن عدم قدرته على تفسير الحوادث، وانطلاقا من هذا الطرح وافقوا سلفهم مقصدا وغاية، فتوصلوا إلى أن النبوة لم تعد الحاجة إليها ملحة في عصور التقدم.
ويمكن تفسير الدين من داخله وتأسيسه على يقينه الذاتي كنظام مستقل، ومن ثم يصبح اللجوء إلى ما هو خارج الطبيعة لا لزوم له.
إذن، القراءات الحداثية للنصوص على هذا ما هي إلا استمداد للنَّظَرِيَّاتِ المعاصرة؛ كالبنيوية، والتفكيكية، ويقوم هؤلاء المقلدون بتطبيق هذه النظريات دون فحص أو تنقيح أو مراعاةٍ لاختلاف البيئات ثقافة وحضارة.
ج-الخلفية الاستشراقية: فأصحاب مشروعات إعادة التاريخ وقراءة التراث الإسلامي قلدوا القراءة الاستشراقية في أبرز سمة لها، وهي اعتبار الدين الإسلامي مستمدا من الثقافات المجاورة له، ولا يعدو كونه قراءة تفسيرية للديانات السابقة، كما يقرر المستشرق (ثيدور نولدكه) صاحب كتاب تاريخ القرآن.
ويتماهى الجابري مع الرؤية الاستشراقية ليبرهن على تشكيلها لثقافته، فيقرر أن الكتاب والسنة وعلومهما أُخذا من الموروث الجاهلي، فيقول: “ليس هناك موروث قديم يمكن عزله عما عبرنا عنه بالفكر الديني العربي والذي نقصد به الكتاب والسنة، كما يمكن أن يُقرآ داخل مجالهما التداولي ويتحدد أساسا بالموروث الجاهلي أي: بنوع الثقافة ومستوى الفكر السائدين في مكة والمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم".
وهذا الموقف المعتبر للكتاب والسنة وآلياتهما على أنهما تأثرا بالموروث الجاهلي لا يخص الجابري، بل هو عند جميع رواد المدرسة الحداثية، ويتم توزيعه على جميع العلوم الإسلامية بما في ذلك الأخلاق واللغة.
فهذا أحمد أمين يرى أن القواعد النحوية كانت على غرار ما وجد في الآداب السريانية في العراق وأنها مستمدة منها، وبالرغم من وضوح الجانب الأخلاقي في القرآن إلا أن الجابري يصر على تجاوز الزمن ليحط رحله في مرحلة متأخرة زمنيا، ويَدَّعِي أن التأليف في الأخلاق ما هو إلا تأثر بالفكر اليوناني والفارسي، ومجاراة للأمم السابقة، وهم في ذلك تبع للمستشرقين في ادعائهم تَوْفِيدَ العلوم الإسلامية، وأنها ليست ذاتية بل منقولة من الثقافات الأخرى.
يمكن القول بأن الحداثيين بمختلف مشاريعهم الفكرية المقترحة من أجل فهم النص الديني لم يستطيعوا وَضعَ رؤى وتصورات منهجية لفهم النصوص الدينية، ومشاريعُهم للفهم لم تساندها أمثلة تطبيقية تبْعثُ على القول بأنَّها ناجحة.
فالقراءة الحداثية للنص تتبنى عدة مناهج مختلفة ومتناقضة، فتجد الحداثي يتبنى الماركسية والبنيوية ونظرية التلقي في آن واحد، بالرغم من أن بعضها قام على أنقاض بعض مما أدى بهم إلى الغموض والتضارب المنهجي، حيث كان التعقيد آلية تعويضية عن الارتباك الفكري والتضارب الذي يتسم به هذا الخطاب، فهم في أنسنتهم للتراث الديني والنزول به عن البعد الرباني، جعلوا من آلياتهم البديلة عن المعايير التأويلية عند الأقدمين آليات عبثية لا تفرض مَعْنًى محددا للنص، وبالرغم من فشو النَّفَسْ الاستدراكي عند هذه المدرسة؛ إلا أنه مع كل فحص موضوعي لمدى الأهلية لنقد النصوص من طرف الحداثيين يتبين عدم استيعابهم للعلوم والمصطلحات التي يحاولون نقاشها.
المحاضرة الثانية: القراءة الحداثية للنص القرآني
أولا: جذور القراءة الحداثية للنص القرآني.
تعود جذور القراءة الحداثية للنص القرآني إلى ما يسمى في الفلسفة بالهيرمينوطيقا، ويذهب معظم الدارسين إلى كون الهيرمينوطيقا أخذت من "هرمس" الإله والرسول الذي كان يعبر المسافة بين تفكير الآلهة وتفكير البشر، كما هو موجود في الأساطير اليونانية، ويزود البشر بما يعينهم على الفهم وتبليغه .
وتعني كلمة hermé اليونانية: القول والتعبير والتأويل والتفسير، وهي كلها دلالات متقاربة. وقد ظهرت كلمة "هيرمينوطيقا" لأول مرة سنة 1654 في عنوان كتاب لدانهاور.
وفي علم اللاهوت تدل الهيرمينوطيقا على فن تأويل وترجمة الكتاب المقدس، فالتأويل هو "العلم الديني بالأصالة والذي يكوّن لب فلسفة الدين... ويقوم عادة بمهمتين متمايزتين تماما: - البحث عن الصحة التاريخية للنص المقدس عن طريق النقد التاريخي، - وفهم معنى النص عن طريق المبادئ اللغوية.
يقول بول ريكور: "تبدأ الهرمينوطيقا عندما لا نكون مسرورين بالانتماء إلى تقليد متوارث فنقطع علاقة الانتماء لنمنحها دلالة ما... كان النص فيما سبق معنى، وأصبح الآن دلالة أي إنجازا لخطاب الذات القارئة".
وينطلق الحداثيون في اعتمادهم على هذا المنهج لقراءة النص القرآني من عدة مسلمات منها:
- أن العالم العربي والإسلامي لا يمكنه التطور والخروج من تخلفه إلا بمسايرة الغرب في مناهج تفكيره للوصول إلى حيث وصل في التقدم الحضاري، بما في ذلك كيفية فهم النصوص الدينية.
- التخلص من قيود النص الديني وضوابطه من سبل التحرر الفكري الضروريان لنهضة أية أمة.
- رفض فكرة الإعجاز اللغوي للقرآن، واعتباره نصا أدبيا كغيره ينتقد ويناقش وبصوب ويخضع للتأويل العقلاني.
- النص القرآني شأنه شأن كل نص فيه "فراغات" تملأ من القارئ عن طريق الذات والخيال.
- النص القرآني أشبه بالكتاب المقدس بعد الترجمة البروتستانتية له واشتداد الجدل حوله مع الكاثوليك أيام الحركة الإصلاحية في أوربا فأصبح النص موضوع شك وصل إلى درجة الفوضى العارمة، فكان البد من التحقق من أصل هذا الكتاب عن طريق المناهج النقدية التي استعملوها في نقد النصوص الأخرى القديمة كالإلياذة والأوديسة وغيرها، وهذا ما أراد الحداثيون العرب فعله بالنص القرآني لكي نتجاوز التخلف والتأخر والجمود لابد من تبني المنهج التاريخي في الدراسات القرآنية على غرار الدراسات التوراتية والإنجيلية.
- استدعاء مكتسبات الحداثة من مناهج ومفاهيم هو الوسيلة للكشف عن المناطق المهمشة من التأويل الإسلامي القديم الذي كان على اشتباك مع أهل التفسير حول النص القرآني.
ثانيا: مناهج الحداثيين في قراءة النص القرآني.
- المنهج الفيلولوجي:
ثمة تقارب بين مصطلحات فقه اللغة وعلم اللغة والفيلولوجيا، فالأول خصصه أهله (العرب) لدراسة لغتهم العربية وما تمتلكه من خصوصيات، ويدرسها كوسيلة وليس كغاية وهو الأقدم من الناحية الزمنية، أما الثاني فيهتم بدراسة جميع أنظمة اللغة في العالم، قد ظهر حديثا في القرن التاسع عشر للهجرة في حين أن الفيلولوجيا تهتم بدراسة اللغات الاغريقية واللاتينية وتتعامل مع النصوص القديمة الميتة المكتوبة كما تهتم بالآثار والنقوش والتحف وتفتقر للتقنين والتقعيد.
وفي النصوص الدينية فالفيلولوجيا تعني دراسة النصوص المكتوبة من حيث إعدادها وطبعها، ومن حيث نقد صحتها، ومن حيث مصادرها، وقد كانت له نتائجه الإيجابية في نصوص الكتاب المقدس عند المسيحيين نظرا للاضطراب الذي وقع فيه من تناقض بين الأفكار وتعدد في الأقوال بين عدد نسخه المخطوطة وتعدد النسخ. وحاول الحداثيون إعمال تلك الآليات في قراءة النص القرآني.
- المنهج التاريخي
هو الدراسة النقدية للوثائق المكتوبة من حيث الشكل ومن حيث المضمون، نسبتها إلى زمنها، اللغة التي كتبت بها، من كتبها، المضمون الذي تحمله، وهو الأمر الذي حصل عند مؤرخي الكتاب المقدس بعهديه، فتبين بأنها ليست الوثيقة الأصلية، مخطوطاتها متعددة ومتناقضة، تعرضت لترجمات مختلفة، مدونوها متعددون ومجهولون أيضا، وزمنها يعود لقرون طويلة، قد لا يعرف امتدادها.
ويطلق على هذا المنهج التاريخية: Historicit وهي مسلك في قراءة النصوص الدينية، يقوم على افتراض نسبيتها، عن طريق خضوعها لظرفية زمانية ومكانية غير مطلقة.
فالأرخنة هي القول بتاريخية النص القرآني، أي أنه يعكس واقعا تاريخيا وتصورات ثقافية تاريخية، فالتمسك بدلالتها الحرفية يعني تثبيت لواقع تجاوزه الزمن.
وهذه الأرخنة تستهدف تجاوز عائق القول بالأحكام الأزلية الثابتة، فالنص الديني شأنه شأن أي نص تاريخي إنساني لا قدسية له ولا إطلاقية، فهو مرتبط بظروف نزوله وأسبابه مما يتيح أن يكون معناه محدودا بزمن تلك الظروف والأسباب.
- الأنسنة.
الأنسنَة (Humanism, Humanistic, Humanity ) لفظٌ اشتُقَّ من الإنسان ، وبُنيَ على بناء الفعلَلَة، وهو بناء مصدري يُراد به تحويل قضية ما إلى قضية إنسانية. والأنسنة نزعةٌ فلسفية أخلاقية غربية تُركّزُ على قيمة الإنسان وكفاءَته، وتنتهجُ التفكيرَ العقلانيّ والمنهج التجريبيّ.
وتعني الأنسة في الدراسات القرآنية رفع القداسة الدينية الإلهية عن النص القرآني ومن لغة الوحي المتعالي إلى الوضع البشري شأن بقية الألسن البشرية بلغتهم، فالقرآن منتج ثقافي وليس وحيا متعاليا، لغته نتاج الواقع العربي التاريخي والاجتماعي ، فهو عند أودونيس يقرأ كما تقرأ النصوص الأدبية، فهو قابل لكل الشروط النقدية كأي خطاب بشري.
فالأنسنة تجعل من الإنسان محورا لتفسير الكون وتتنكر لأي معرفة أخرى من خارج الإنسان بما فيها الوحي والدين عموما. فالوحي إذا ما أردنا فهمه فلابد أن ينتقل من الوضع الإلهي إلى الوضع الإنساني. وقد تفرع عن هذا المعنى نسبية فهم النص وبالتالي تعدد القراءات والتأويلات للنص الواحد.
- العقلنة:
العقلانية هي النظرة المعرفية التي تعد المنطق (العقل) مصدرًا رئيسيًا واختبارًا للمعرفة أو وجهة نظر تميل إلى اعتبار المنطق (العقل) مصدرًا للمعرفة أو التبرير، كما تعرّف العقلانية على أنها المنهجية أو النظرية التي يكون معيار الحقيقة فيها فكريًا واستنباطيًا وليس حسيًا.
- المنهج التفكيكي: Déconstruction.
التفكيكية منهج نقدي أسسه الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا (1930-2004)، ويهدف من خلاله دراسة النصوص التي غلبت عليها صفة المطلق و المثالية اعتمادا على هذا المنهج التفكيكي الذي لا يعطي اعتبارا للمقدس، فيولد من خلاله أشياء كثيرة سكت عنها النقاد القدماء.
يعتَبرُ هذا المذهبُ أنَّه لا يمكن الوصولُ بشكلٍ من الأشكال إلى فهمٍ واستيعابٍ كاملٍ أو متماسكٍ للنص الأدبي مهما كان هذا النصُّ، فالقراءةُ وتفسير النصوص الأدبية بشكلٍ عامّ هي عملية ذاتية يقومُ بها القارئُ وكلُّ قارئٍ يمكن أن يفسِّرَ النصَّ حسب رؤيته وحسبَ مشاعره وظروفه المحيطة وتجربته التي تؤثر جميعُها في قراءته لهذا النصِّ.
فعند تفسير نصٍّ قرآني، نحتاج معرفة مناسبته، وزمان نزوله، ومكان نزوله؛ مكي أم مدني، والناسخ والمنسوخ فيه، وغير ذلك من المعارِف التي لا بدَّ للمفسِّر -زيادةً على معرفته باللغة والصرف والبلاغة- من معرفتها، وإتقان أصولها وفروعها. ولكنَّ التفكيك الذي نتحدَّث عنه، يُهمل هذه الملابسات جميعها، ولا يُعوِّل عليها. يُعوِّل التفكيك على القارئ وحْده، لا على النص، ولا على المؤلِّف، ولا على مصدر النص، ولا على مناسبته، وجوِّه، وملابسات تأليفه.
- المنهج البنيوي:
المنهج البنيوي أو البنيوية tructuralismes يقوم على حصر القيمة في النص في ذاته، ولا يهم مؤلفه ولا مقاصده ولا حتى أوضاعه التي أنتج فيها خطابه. فالنص كمعطى يدرس من خلال أجزائه وتراكيبه وجمله وبنيته ككل أي قبوله للتفكيك والتركيب.
ثالثا: نصوص مختارة لتطبيق مناهج الحداثيين في قراءة النص القرآني.
توظيف البنيوية:
يوظف محمد أركون في تحليله للخطاب القرآني مفهوم: «البنية العاملية» على أنّها «مجموعة الضمائر التي تتجادل داخل النصّ القرآني».
فمثلًا، أثناء تحليله للبنيات النحوية لسورة الفاتحة اعتبر أركون أنّ آيات الفاتحة تنقسم إلى نوعين من الجُمَل: جُمل أصلية، وعددها أربع: 1- {بِسْمِ اللَّهِ}. 2- {الْحَمْدُ لِلَّهِ}. 3- {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. 4- {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}، وما سواها: جُمَل شارحة،.
وأمّا ما يتعلّق بالنظم والإيقاع في السورة الكريمة، فقد تكلّم عن «وجود قافية (إيم) متناوبة مع قافية (إين) في سورة الفاتحة".
كما يرفض أركون تسمية “القرآن” الكريم، ويعوضها ب”الظاهرة القرآنية”؛ لأن كلمة “قرآن” “مثقلة بالشحنات والمضامين اللاهوتية والطقوس الشعائرية”، ولأنها تقف عائقا أمام المراجعة النقدية الجذرية للتراث الإسلامي وإعادة تشكليه. فأركون يتحدث عن الظاهرة القرآنية كما يتحدث عن الظواهر العلمية والاجتماعية، ويهدف من وراء ذلك إلى “وضع كل التركيبات العقائدية الإسلامية وكل التحديثات اللاهوتية والتشريعية والأدبية والبلاغية والتفسيرية.. إلخ على مسافة نقدية كافية كباحث علمي".
إنه يرفض التعريف التبسيطي للوحي، وعبارات “قال الله تعالى” عند بداية الاستشهاد، و”صدق الله العظيم” عند الانتهاء منه؛ لأن ذلك يغلق مجال المناقشة حول التأليف، أو حول النص المستشهد به. ويعيد تعريف القرآن من جديد باعتباره حدثا يحصل أول مرة في التاريخ، فهو “التجلي التاريخي لخطاب شفهي، في زمن ومكان محددين”(5). فأركون يعرف القرآن الكريم بكونه خطابا شفهيا، ويفرق بينه وبين القرآن المدون في المصحف؛ لأن عملية الانتقال من القرآن الشفهي الذي تلفظ به النبي طيلة ثلاثة وعشرين سنة إلى القرآن المجموع والمدون في الصحف، عرفت عدة ملابسات مؤثرة من حذف، وانتخاب، وتلاعب، فعملية الجمع مرت في جو من الصراع على السلطة والمشروعية.
توظيف التفكيكية.
اعتمد الجابري على المنهج التفكيكي الذي يعتمد على الفصل بين قُطبَي العلامة (الدالّ والمدلول)؛ حيث بدأ الجابري أوّلًا بالتشكيك في معنى (الآية) في القرآن الكريم بقوله: "جميع العبارات القرآنية التي ورد فيها لفظ (آية) إنما تُحِيل إلى معنى (العلامة) والحجة والدليل".
ثمّ شرع في دراسة آية المحكم والمتشابه: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}[آل عمران: 7] في سياق الآيات السبع الأولى من سورة آل عمران.
وخَلصَ الجابري -اعتمادًا على العلامات وعلى أسباب النزول- إلى أنّ "الآيات المحكمات هي العلامات والدلائل والظواهر الكونية التي تدل على أن الله إله واحد"، وأنّ الآيات المتشابهات "هي العلامات التي أراد الله بها إثبات فعل خارق للعادة لأنبيائه ورسله".
استخدم الجابري إذن التفكيكية التي تُتيح للقارئ تفسير العلامات بالمعنى الذي يشاء.
ويرى الشرفي أنّ لفظ القرآن لا يمكن إطلاقه إلّا على الرسالة الشفوية التي بلّغها الرسول -صلى الله عليه وسلم- للصحابة، وأنّ «الذِّكْر الذي وعد الله بحفظه هو المحتوى وليس الظرف".
كما يرى أنّ الكيفيّات التي رافقت نصّ القرآن دخلها الكثير من الوضع، وقد تناسى الشرفي أنّ تلقِّي القرآن كان يعتمد على المشافهة والكتابة في آن واحد؛ حيث إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يراجع ما كتبه الكُتّاب في مصاحفهم.
ويُميِّز الشرفي بين "القراءة التفسيرية في القديم حين كانت من اختصاص المؤمنين، والقراءة التفسيرية الحديثة" التي هي مِلْكٌ مشاعٌ بين المؤهَّلِين فنِّــيًّا للقيام بها مهما كانت عقيدتهم.
ويُوضِّح الشرفي بأنّ الدّارِس المـُقارِن لا يُرضيه التفسير التقليدي؛ لأنّ "منهجه يفرض عليه عدم المفاضلة بين التأويلات". كما قَرّر الشرفي بأنّ "العبرة ليست بخصوص السبب ولا بعموم اللفظ معًا، بل في ما وراء السبب الخاص واللفظ المستعمل له يتعيّن البحث عن الغاية والقصد. وفي هذا البحث مجال لاختلاف التأويل بحسب احتياجات الناس واختلاف بيئاتهم وأزمنتهم وثقافاتهم"، مُستنِدًا إلى أمثلة تشكك في فرضية أركان الإسلام.
توظيف التاريخية.
تعامل الجابري مع قضية جمع القرآن الكريم وتدوينه بمنهج خاص به يجمع بين التشكيك في الروايات الحديثية، وبين البحث عن الروايات الشاذة المرفوضة لدى علماء الأمة، وبين الانتقائية في الأخذ بالروايات الحديثية الخاص بالجمع والتدوين، مع إحيائه لشبهات المستشرقين المتهافتة.
جمع القرآن الكريم وتدوينه -حسب الجابري- من قبل الخليفة الثالث عثمان بن عفان شابته مجموعة اختلالات، ويبين الجابري ذلك بقوله: “كان مفرقا قبل تدوين مصحف عثمان، وقد حدثت فيه أخطاء ونسيان وتبديل وحذف ومحو”، ثم شكك بعد ذلك حتى في بقاء مصحف عثمان دون تغيير، وكانت خلاصة بحثه في الموضوع، “أنه ليس ثمة أدلة قاطعة على حدوث زيادة أو نقصان في القرآن كما هو في المصحف بين أيدي الناس، منذ جمعه زمن عثمان. أما قبل ذلك، فالقرآن كان مفرقا في “صحف” وفي صدور الصحابة، ومن المؤكد أن ما كان يتوفر عليه هذا الصحابي أو ذلك من القرآن مكتوبا أو محفوظا كان يختلف عما هو عند غيره كمّا وترتيبا، ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه، زمن عثمان أو قبل ذلك، فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن نفسه ينص على إمكانية النسيان والتبديل والنسخ”.
وفي نفس الاتجاه تسير قراءة المستشار جواد عبد الحميد في كتابه “الدين والتدين”، الذي ينطلق فيه من أن النص الديني يتضمن ما هو مطلق ثابت، وهو الإيمان بالله تعالى وبالأخلاق الكلية، وما هو نسبي متغير مرتبط بالاجتماع والتاريخ، لا يمكن إلحاقه بالدين، ألا وهو التشريع؛ لأنه مرتبط بما هو اجتماعي متغير تضخم عبر الزمن وصار أكبر مما هو مطلق ثابت في البنية الدينية، وبالتالي نال صفة القداسة.
من هذه الرؤية للنص الديني يصدر الكاتب رأيه في طبيعة وبنية النص الديني، محاولا تسليط الضوء على تأثير التاريخ والاجتماع في تشكيل النص الديني.
في هذا الإطار يصنف علوم القرآن، الصادرة عن ثقافة عصر التدوين التي تطور إليها التدين الإسلامي، في القرنين الثاني والثالث الهجريين “تبلورت علوم القرآن كعنوان مستقل في وقت متأخر، ومع ذلك فإن مقولاتها الأولية ترجع إلى الملابسات المبكرة لعملية جمع القرآن التي أسفرت عن إنشاء المصحف، وما صاحبها، في غضون الفتنة، من مطاعن تتعلق بمبدأ الجمع، وترتيب السور والآيات، وما عرف بنسخ التلاوة. ودفع بها إلى تبني مقولة النزول المسبق والمجمل للقرآن، كما تم جمعه أو قريبا منه، في اللوح المحفوظ”.
وفكرة الكاتب هي تقسيم النص إلى قسمين: منه ما هو إيماني صحيح، بقي مطلقا، لم يتغير، ومنه ما هو تشريعي متعلق بأفعال الناس، نرفضه لأنه يعكس تأثير الواقع الاجتماعي العربي في النص الديني. وهذا يتطابق مع مقولة: فصل الدين عن الدولة.
المحاضرة الثالثة:
القراءة الحداثية للسنة النبوية
أولا: جذور الاتجاه الحداثي في دراسة السنة.
"الحداثيَّة" أو "القراءة الجديدة" للنَّصِّ الدِّيني، هي قراءةٌ "تأويليَّة" تستمِدُّ آلياتِها من خارجِ نطاقِ "التداول الإسلامي"، بل تأتي وَفقًا للتجربةِ الغربيَّة في فَهمِ النُّصوصِ، واللاهوتيَّة منها خصوصًا، فـلا تريدُ أن تحصِّلَ اعتقادًا من النَّصِّ، بقَدْرِ ما تريد أن تمارِسَ نَقْدَها عليه، واستخدامًا لنظريَّات لُغويَّة حديثة (مثل: البنيويَّة، والتفكيكيَّة، والسيمائيَّة) وهي قراءاتٌ في حقيقتِها اقتَبَسَت كلَّ مُكَوِّناتها من الواقِعِ الحداثيِّ الغَربيِّ في صراعِه مع الدِّينِ، هذا الصِّراع الذي آل، في الغرب، إلى الاشتغالِ بالإنسانِ بعيدًا عن اللهِ (الأنْسَنَة) والاهتمامِ بالعَقلِ خارجًا عن الوَحيِ (العَقْلَنة)، ومراعاةٍ للدُّنيا من غيرِ نظَرٍ إلى الآخِرةِ (الأرْخَنَة).
ثانيا: منطلقات الحداثيين في دراسة السنة.
سلك الحداثيون مع السنة النبوية مسلكهم مع القرآن الكريم ونزعوا عنها صفة القدسية، وقد استندوا في موقفهم هذا على الشبه التي تثار حول ظنية السنة النبوية وقلة المتواتر وكثرة الآحاد، واحتمالية الخطأ والرواية بالمعنى، والكذب والاختلاط الذي قد يطرأ على الرواة أثناء روايتهم للحديث الشريف، إضافة إلى الوضاعين والمتزندقين الذين أكثروا من الكذب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، متناسين الجهود الكبيرة التي وضعها أئمة السنة لحماية السنة من التحريف، والعلوم التي ابتكروها لضبط الرواية، كعلم المصطلح والرجال والعلل وغيرها.
ومن بين المنطلقات التي اعتمدوا عليها:
- التشكيكِ في السُّنَّةِ؛ فهي في الخِطابِ الحداثيِّ وقراءتِه التفكيكيَّة لأصولِه "مجموعات نصيَّة مُغلَقة" ذاتُ بنيَة "تيولوجيَّة- أسطوريَّة" حسَبَ تعبيرِ أركون، قد خضعت"لعمليَّة الانتقاء والاختيار والحذف التعسفيَّة التي فُرِضَت في ظِلِّ الأُمَويين، وأوائِلِ العباسيِّين، أثناء تشكيلِ المجموعات النصيَّة"، كما أنَّ هذه "المجموعات النصيَّة" قد تعَرَّضت لعمليَّة النَّقلِ "الشفاهي" بكُلِّ مشاكِلِها، ولم تُدَوَّن إلَّا متأخرًا، وهذا الوجه "الشفاهي" قام به جيلٌ من الصَّحابة، لا يرتفعون عن مستوى الشبُّهُاتِ، بل تاريخُهم تختلِطُ فيه "الحكايات الصحيحة" بـ "الحكايات المزوَّرة"!
- التسويَّةِ في الاستشهادِ بين السُّنَّة، وسائِرِ الخطابات الأخرى، وإخضاعِها لـ "سنن القراءة" و"مناهج" الألسنيَّات الحديثة، وتحليلِ الخِطابِ التاريخيِّ ونَقْدِه، باعتبارِها "نصًا تراثيًّا" شأنُها في ذلك شأنُ بقيَّة النصوص، وهكذا يصبحُ النَّصُّ النَّبويُّ نفسُه موضِعَ "المساءلة" ما إذا كان حُجَّةً أم لا، فضلًا عن تضَمُّنِه رسالةً للبشريَّة، أو كونِه هُدًى وبشرى للعالَمين!
- (عَقْلَنةِ) السُّنَّةِ، واعتبارِ العَقلِ حاكمًا وقاضيًا عليها، وكذلك اعتبارُ "الواقع" حاكمًا على النَّصِّ، ومتبوعًا لا تابعًا؛ فسُلطة العَقلِ في القراءة الحداثيَّة هي السُّلطة الوحيدة التي يُتعامَلُ على أساسِها مع السُّنَّة النبويَّة، بل مع النُّصوص الدينيَّة كافَّةً.
ثالثا: معايير نقد السنة عند الحداثيين.
- الاقتصار على نقد المتن فقط دون السند
يقول جمال البنا: "معيار الصحة هو المتن وليس السند؛ لأن هذا سيجعل المعنى هو الفيصل".
ويقول خليل عبد الكريم: "نحن لا نقوم الأحاديث بالميز ان الذي كان يمسكه علماء الجرح والتعديل، إن لنا مقياسا مغايرا، فنحن نقبلها على علاتها، .... لا نوزنها بميزان صدورها من محمد أو هذا أو ذاك من الصحابة، ولكننا نزنها بميزان دلالتها عما كان يعتمل في ذلك المجتمع... وهذه الأحاديث حتى الموضوعة نستشف منها الكثير... إذ مهما بلغ عوارها فإنها نتاج عصرها، وثمرة بيئتها".
- عرض السنة على القرآن
قد يحدث التعارض بين السنة والقرآن بسبب الفهم الخاطئ للآية أو الحديث، كما حدث للسيدة عائشة رضي الله عنها، وذلك فيما أخرجه الشيخان في صحيحهما أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى (فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا) قالت فقال: إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك ).
فمسلك العلماء هو محاولة التوفيق بين نص الحديث والقرآن قدر المستطاع، إلا أن الحداثيين توسعوا في ذلك توسعا كبيرا فردوا أي حديث يوهم التعارض مع القرآن بالتجويز والنظر العقلي المحض دون ضابط معين، وبذلك فأي حديث أو حكم جاء في السنة ولم ينص عليه القرآن فهو مردود عندهم، فردوا أحاديث المعجزات الحسية للنبي وردوا حد الرجم، وحد الردة، وحد الخمر، وغيرها.
ومن أمثلة الأحاديث التي ردوها بدعوى التعارض مع القرآن: ما رواه البخاري ومسلم عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: اهْجُهُمْ، أَوْ هَاجِهِمْ، وَجِبْرِيلُ مَعَكَ.
قال زكريا أوزون: "أن يأمر الرسول بهجاء المعارضين له هو أمر فيه شك؛ لأن الباري- عز وجل – قال فيه: "وإنك لعلى خلق عظيم"، ولكن أن يكون جبريل الأمين مع الشاعر حسان في هجائه حيث يصبح شعره مؤيدا من السماء فهذا أمر لا يمكن قبول نسبه إلى الرسول الكريم.
ويقول جمال البنا: "وإذا كان تطبيق هذا المعيار يؤدي بمئات أو أكثر من الأحاديث التي احتفظ بها المجتمع الإسلامي ألف عام، فقد لا يكون من المبالغة القول: إن هذا الاحتفاظ كان من أكبر أسباب تخلف هذا المجتمع، وأنه لن يتقدم إلا عندما يتخلص من هذه الأحاديث التي تخالف القرآن".
- عرض السنة على العقل.
- عرض السنة على روح الإسلام.
وهو مصطلح عام استعمله بعض الحداثيين لرد أحاديث يوهم ظاهرها التعارض مع مقاصد الدين وغاياته، مثال ذلك رد الدكتور حسن حنفي أحاديث الإسراء والمعراج لمعارضتها روح الإسلام، قال: "فالإسلام دين واقعي ورسالة إنسانية اكتمل فيها الوحي، واستقل فيها العقل، وأصبح للإرادة حرية الاختيار، ولكن الرواية عود إلى الوراء إلى قصص الأنبياء عند بني إسرائيل، حتى لا يكون خاتم الأنبياء أقل من الأنبياء السابقين".
ومن ذلك أيضا رد الأحاديث التي تتحدث عن المرأة في حقوقها ومكانتها من الرجل، وضوابط حجابها وعملها، يقول خليل عبد الكريم: "شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، هل هذه القاعدة تتفق مع وضع المرأة هذه الأيام بعد حصولها على أعلى الشهادات من أرقى الجامعات".
ويقول جمال البنا: "نحن نتوقف أمام كثير من الأحاديث التي جاءت عن المرأة بدءا من خلقها من ضلع أعوج، حتى حجابها حتى لا تظهر إلا عينا واحدة".
فهذا رد مبني على وجهة نظر عقلي محض لا يسنده دليل صريح، بل خلفيات فكرية متعلقة بالمرأة عند هؤلاء، وكثير منها يتساوق مع النظرة الغربية المعاصرة لها.
- عرض السنة على الواقع والحياة الاجتماعية والذوق والشعور.
يقول زكريا أوزون:" أما الأحاديث التي تعارض العلم والمنطق والذوق السليم فنتركها دون حرج".
فما رده الحداثيون حديث الذبابة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه ) رواه أبو داود وابن حبان. بزعم تعارض معطياته مع نتائج وبحوث علمية ومع الذوق الإنساني السليم.
ورد حديث إذا أكَلَ أحَدُكُمْ فلا يَمْسَحْ يَدَهُ حتَّى يَلْعَقَها أوْ يُلْعِقَها، قال: "يعرف هذا الحديث أيضا بحديث البزازة، وهي ظاهرة تنافي الذوق السليم وتجانب الطب الوقائي".
رابعا: نقد القراءة الحداثية للسنة.
"القراءة الحداثيَّة" قد وقعت في جملةِ أخطاءٍ (آفات) منهجيَّة، تُفقِدُها قيمتَها كما تُفقِدُ النَّتائِجَ المتوصَّلَ إليها مصداقِيَّتَها؛ وذلك فيما أسَمِّيه بـ"الغيبات الأربع" والتي يمكِنُ تمثُّلُها على النَّحوِ التالي:
1. غيابُ البُعدِ المصدري للنُّصوصِ (أزمة القراءة الحداثيَّة مع النَّصِّ الدِّيني) ولا شكَّ أنَّ غيابَ "البعد المصدري" للنَّصِّ الدِّيني، أو "تغييبه" في القراءة الحداثيَّة يُعَدُّ خطأً مَنهجيًّا، بل يمثِّلُ "أزمة" و"خَطبًا" أيَّ خَطْبٍ؛ إذ النُّصوصُ الدينيَّة لا تقبَلُ الانفصالَ عن قائِلِها، وعن مراده؛ فالقرآنُ هو كلامُ اللهِ سبحانه وتعالى، والحديثُ هو من الوَحيِ الذي تكَلَّم به الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأيُّ نظرةٍ إلى كلام اللهِ عزَّ وجَلَّ، أو كلامِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تستبعِدُ "المتكلم" تقعُ في محاذيرَ كثيرةٍ، ليس أقَلُّها عَدَمَ إدراكِ عَظَمةِ مَصدَرِ النَّصِّ الذي يُتعامَلُ معه ويُبَيَّن مرادُه، فهمًا وتنزيلًا، واستنباطًا واستدلالًا، ومِن ثَمَّ إعطاء المشروعيَّة لكُلِّ عَمَليَّات النَّقدِ والتَّخطئةِ والمراجَعةِ والتصحيحِ والتنقيحِ، وما يستوجِبُ الحُكمَ بالنَّقصِ أو وُجودَ الخَلَلِ والخَطَأِ، وهَدَم مصداقيَّته.
2. غيابُ القراءةِ الجامِعةِ (القراءة الحداثيَّة المتهافِتة للنَّصِّ الدِّيني)، وهذا واضِحٌ في تناوُلِهم لبعضِ الآياتِ القرآنيَّة، والأحاديثِ النبويَّة المشَرَّفة، التي تتحَدَّث عن: حجابِ المرأةِ، وميراثِها، ومنزلتها في الإسلامِ، وإقامة بعض الحدود....وغير ذلك من أوهامٍ وشبُهاتٍ، مُقتَطَعة من سياقها؛ فكانت قراءتُهم لها قراءةً "متهافتة" تعتمِدُ آلياتٍ خاصَّةً لا يستعانُ بها على فَهمِ المعنى المرادِ للنَّصِّ، ولا تؤيِّدُ الأفكارَ المبثوثةَ فيه، بقَدْرِ ما تجعَلُه وثيقةً تخدُمُ مصالحَ فئةٍ مُعَيَّنةٍ، في ظروفٍ تاريخيَّةٍ مُعَيَّنةٍ، وهذا يخالِفُ شَرْطَ القراءةِ الصحيحة التي تُعامِلُ القرآنَ الكريمَ، والسُّنَّةَ الشَّريفة "كاللفظة الواحدة"، وأنَّ كُلَّ جزءٍ من هذه اللفظةِ ينبغي النَّظَرُ إليه في ضوء علاقتِه مع الأجزاءِ الأخرى.
3. غيابُ الإبداعِ الموصولِ (القراءة الحداثيَّة وأزمة المنهج)، وهذه هي مُشكِلةُ الحداثةِ الأولى في مقاربتِها النَّصَّ الدِّيني، وهي الدَّعوةُ إلى "ضرورة" قراءةِ النَّصِّ الدِّيني خارجَ "تداوُلِه" أي: خارجَ نطاقِ أيِّ قراءةٍ أسبقيَّة تراثيَّة له، في فَصلٍ تامٍّ بين النَّصِّ الدِّينيِّ الإسلاميِّ، وكُلِّ القراءاتِ الضَّابطةِ لفَهْمِه وتفسيرِه في التراثِ العربيِّ الإسلاميِّ، وذلك لصالحِ المنهجيَّةِ الغربيَّةِ المسيحيَّةِ في تحليلِ الخِطابِ، وقراءةِ النُّصوصِ؛ فراحوا يُسقِطون على "النَّصِّ الدِّيني" الإسلاميِّ كُلَّ ما ظَفِروا به من "آليات القراءة" و"أدواتها" في نتاجِ الآخَرين، وأطلقوا العِنان لقراءة النَّصِّ الدِّيني وفَهْمِه وتحليلِه، من خلالِها.
4. غيابُ المرجعيَّة اللغويَّة (القراءة الحداثيَّة والانحراف عن معهود العرب في الخطاب)، ولعل غياب"المرجعيَّة اللغويَّة" هو الخطأُ بل "الخطيئة" الكبرى، ومن "الإصابات" الفِكريَّة البالغة التي وقع فيها الحَدَاثيُّون في أثناءِ مُقاربتِهم النَّصَّ الدِّينيَّ؛ فمِن ضوابِطِ القِراءةِ الصَّحيحةِ: أنَّ مُقاربةَ أيِّ نَصٍّ لُغَويٍّ تستدعي الوقوفَ على حدودِ لُغَتِه التي تحمِلُ بلاغَه، ومعرفةَ مقاصِدِ أصحابِها في كلاِمهم، وأن يُؤَوَّلَ الكلامُ بما يوافِقُ "معهود الخطاب المتبادَل بين المتكلِّمين" و "عرف المخاطِب" و"عاداته المطَّرِدة".
حين يَؤُولُ أمرُ "النَّصِّ الدِّيني" قرآنًا وسُنَّةً هذا المآلَ في قراءاتِ الحَداثيِّين؛ فإنَّ الاحتكامَ إلى "منهجيَّة" توجِّه القراءةَ، وتضبِطُ مَسارَها، فهمًا وتفسيرًا وتأويلًا، وتحمي "النَّصَّ" من أن يكونَ مجالًا للتزَيُّدِ والإقحامِ، أو العَبثِ واللَّهوِ، وتمكِّنُ من "الفهم" الصَّحيح لمقاصِدِه، يكونُ أمرًا ضروريًّا، فمَن لم يكن "مقياسُه" مضبوطًا كُلَّ الضَّبطِ، فإنَّ المعانيَ تختَلِطُ عليه وتمتَزِجُ، ووقع في"التِّيه" الذي أدخَلَتنا فيه الحداثةُ وما بعدها! وهذه "المنهجيَّة" محكومةٌ بأصلٍ عامٍّ يمثل "مرجعيَّة" لها، وهو: أن تكونَ "قراءةُ" النَّصِّ الدِّينيِّ الإسلاميِّ على "طريقةِ العَرَبِ في خِطابِها" و "مسالِكِها في تقريرِ معانيها" و "مَنازعِها في أنواعِ مخاطباتها" و "عادات اللِّسانِ العَربيِّ في الاستعمالِ، وخصوصيَّاته في توزيعِ المعاني على الألفاظِ" وأن يُفهَمَ وَفقَ مَدلولِه العربيِّ الذي يتبادَرُ إلى الذِّهنِ، من دون لَيٍّ ولا إغرابٍ، ولا تعطيلٍ لِمغزى، أو إقحامٍ لمعنى.
أسباب استشكال الحديث النبوي، وميادينه عند الحداثيين.
أولا: أسباب الاستشكال المتعلقة بقارئ الحديث.
- التقصير في فهم معنى الحديث.
حديث عذاب القبر للنميمة وعدم التزه من البول، استشكل الحداثيون المساواة بين النميمة وعدم التنزه من البول باعتباره أمرا يسيرا.
حديث: "من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة"، استشكل بعض الحداثيين صيغة العموم، بالقول: كيف لو بناه كافر هل له فيه أجر.
- التقصير في فهم سياق الحديث.
حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، مشكله عند الحداثيين أن فيه ذما لفئة الضعفاء والمعوقين في المجتمع. والسياق يدل على غير ذلك، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى.
- عدم العلم بضعف الحديث المشكل.
حديث: قطعنا قطع الله أثره.
عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أنى حى إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نزل بتبوك إلى نخلة فقال « هذه قبلتنا ». ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال « قطع صلاتنا قطع الله أثره ». فما قمت عليها إلى يومى هذا.
وهو حديث منكر رواه أبو داود، لكن بعض الحداثيين استشكل ما ورد فيه من الوعيد وجعله سبة في رواة الحديث.
- تأثير الخلفية الفكرية والبيئة الثقافية.
الجرأة على النص النبوي. (بناء على المنطلقات الفكرية والفلسفية الغربية)
استعمال المناهج الغربية في قراءة النص النبوي. (تأويل النص بعيدا عن حقيقة وشخصية مؤلفه)، من ذلك تأويل كل الأخبار الغيبية تأويلا معاصرا، أو إدراجها ضمن الأسطورة. بمعنى نزع صفة الإعجاز عن النص النبوي.
اعتماد التاريخانية، أي أن سنة النبي عليه السلام جاءت في بيئة زمانية ومكانية معينة فهي لا تصلح إلا لذلك الزمن.
ثانيا: أسباب الاستشكال المتعلقة بنص الحديث.
- إيهام النص النبوي مخالفة العقل والحس.
مثال ذلك استشكال حديث "إسلام الشيطان" "ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير"، بأنه مناف لسنة التكليف.
حديث صياح الديكة إذا رأت ملكا، عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا ». بأن الملائكة موجودون في كل وقت وكذا الشياطين وبذلك لا يتوقف الصياح أو النهيق أبدا.
- إيهام الحديث مخالفة صريح القرآن.
حديث سحر النبي عليه السلام، يتعارض مع نفي القرآن لذلك نفيا قاطعا. عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق قال فيما ذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذي أروان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين قلت يا رسول الله أفأخرجته قال لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت
ورد بأن السحر وقع على جوارحه لا على روحه.
أحاديث مباشرة الحائض: عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفست قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم.
ورد بأن المباشرة المقصودة في القرآن .تعني الجماع وهو ما لم يقع من رسول الله.
- إيهام الحديث معارضة الأحاديث الصحيحة.
ثالثا: مجالات استشكال الحديث النبوي
- مجال المعجزات.
سبب النقد الموجه لأحاديث هذا المجال معارضة ظواهر هذه الأحاديث للدليل العقلي والحسي، باعتبارهما معيار المعرفة الأكثر دقة، وبالتالي رد كل ما هو واقع خارج دائرة العقل والنظر، يقول حسن حنفي: "السمعيات مثل عذاب القبر، وعلامات الساعة، مثل: انشقاق القمر، وشروق الشمس من المغرب، وغروبها من المشرق، وخروج الدابة، والصراع بين يأجوج ومأجوج، وظهور المسيح الدجال، وكذلك الصراط والميزان والحوض وإنطاق الجوارح، وتطاير الكتب، وأحوال أهل الجنة والنار...، هي من السمعيات التي لا يمكن تأييدها بالحس والمشاهدة والتجربة أو العقل والاستدلال، ولذلك تظل ظنية ولا ترتقي إلى مرتبة اليقين".
وكذلك رد عبد المجيد الشرفي –مثلا- لأحاديث نبع الماء من بين أصابعه، وتكثير الطعام.
- مجال المرأة.
ينطلق الحداثيون في طروحاتهم حول الأحاديث الواردة في النساء من منطلق الدفاع عن حرية المرأة المطلقة ومساوتها بالرجل مساواة تامة، وبالتالي رد كل حديث يثبت تلك الفروق أو يضع حدودا بين الرجل والمرأة أو يضيق من حريتها، ومن منطلق هيمنة العقل (الذكوري) في المجتمعات العربية، ومن نماذج ذلك:
كتاب رجاء بن سلامة "بنيان الفحولة" في نقد حديث "لعن الواشمة والواصلة والمتفلجة"، باعتباره إنقاصا من قيمة المرأة وتحكما في حريتها في الزينة والتجمل، وكذا رد حديث" ناقصات عقل ودين"، باعتباره تكريسا للماقبليات الدينية والثقافية حول المرأة.
ومن ذلك كتاب فاطمة المرنيسي (النبي والنساء)، حيث انتقدت جملة من أحاديث الفقه مثل حديث: "يقطع صلاة المرء الحمار والمرأة والكلب"، بأنه يحط من قيمة المرأة بجعلها في مرتبة الحيوان، وحديث "الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار".
- مجال الغيبيات.
- مجال السياسة الشرعية.
من نماذج ما كتبه بسام الجمل في نقد أحاديث الخلافة، حيث اعتبر ورود لفظ الخلافة في احاديث الرسول، وهو لفظ حادث، دليل على وجود ما يسمى بالتنصيص السياسي، مثل حديث البخاري: عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش.
ومن ذلك كتاب عبد الرزاق عيد (سدنة هياكل الوهم)، حيث رد فيه أحاديث طاعة ولي الأمر مطلقا، باعتبارها مكرسة للتسلط والحكم الجائر، كحديث البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة".
- Enseignant: HADJMAHAMMED KACEM
- Enseignant: MAACHE LEILA
- Enseignant: HAMMOU CHIHANI
- Enseignant: Mustafa KHIRENNAS
